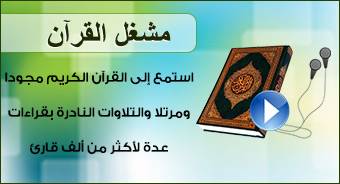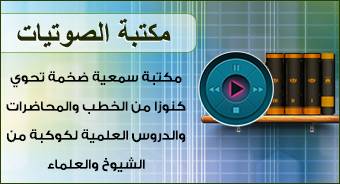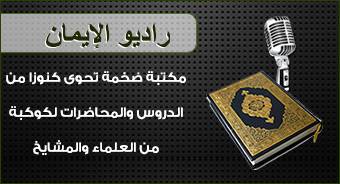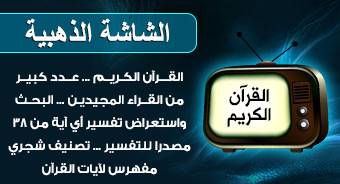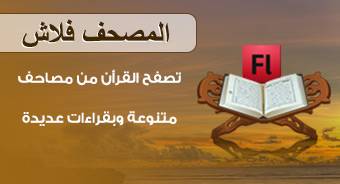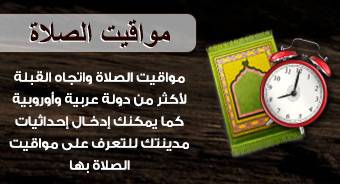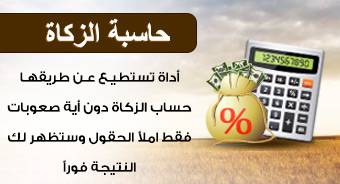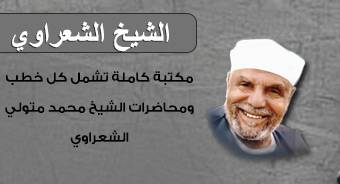.من أقوال المفسرين:
.من أقوال المفسرين:
 .قال الفخر:
.قال الفخر:
{قُلْ إِنْ أدْرِي أقرِيبٌ ما تُوعدُون أمْ يجْعلُ لهُ ربِّي أمدا (25)}قال مقاتل: لما سمعوا قوله:
{حتى إِذا رأوْاْ ما يُوعدُون فسيعْلمُون منْ أضْعفُ ناصِرا وأقلُّ عددا} [الجن: 24] قال النضر بن الحرث: متى يكون هذا الذي توعدنا به؟ فأنزل الله تعالى:
{قُلْ إِنْ أدْرِى أقرِيبٌ مّا تُوعدُون} إلى آخره والمعنى أن وقوعه متيقن، أما وقت وقوعه فغير معلوم، وقوله:
{أمْ يجْعلُ لهُ ربّى أمدا} أي غاية وبعدا وهذا كقوله:
{وإِنْ أدْرِى أقرِيبٌ أم بعِيدٌ مّا تُوعدُون} [الأنبياء: 109] فإن قيل: أليس أنه قال:
«بعثت أنا والساعة كهاتين» فكان عالما بقرب وقوع القيامة، فكيف قال: هاهنا لا أدري أقريب أم بعيد؟ قلنا: المراد بقرب وقوعه هو أن ما بقي من الدنيا أقل مما انقضى، فهذا القدر من القرب معلوم، وأما معنى معرفة القرب القريب وعدم ذلك فغير معلوم.ثم قال تعالى:
{عالم الغيب فلا يُظْهِرُ على غيْبِهِ أحدا إِلاّ منِ ارتضى مِن رّسُولٍ} لفظة (من) في قوله:
{مِن رّسُولٍ} تبيين لمن ارتضى يعني أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي يكون رسولا، قال صاحب (الكشاف)، وفي هذا إبطال الكرامات لأن الذين تضاف الكرامات إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل، وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب، وفيها أيضا إبطال الكهانة والسحر والتنجيم لأن أصحابها أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط، قال الواحدي: وفي هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت أو غير ذلك فقد كفر بما في القرآن.واعلم أن الواحدي يجوز الكرامات وأن يلهم الله أولياءه وقوع بعض الوقائع في المستقبل ونسبة الآية إلى الصورتين واحدة فإن جعل الآية دالة على المنع من أحكام النجوم فينبغي أن يجعلها دالة على المنع من الكرامات على ما قاله صاحب (الكشاف)، وإن زعم أنها لا تدل على المنع من الإلهامات الحاصلة للأولياء فينبغي أن لا يجعلها دالة على المنع من الدلائل النجومية، فأما التحكم بدلالتها على المنع من الأحكام النجومية وعدم دلالتها على الإلهامات الحاصلة للأولياء فمجرد التشهي، وعندي أن الآية لا دلالة فيها على شيء مما قالوه والذي تدل عليه أن قوله:
{على غيْبِهِ} ليس فيه صيغة عموم فيكفي في العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه فنحمله على وقت وقوع القيامة فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لأحد فلا يبقى في الآية دلالة على أنه لا يظهر شيئا من الغيوب لأحد، والذي يؤكد هذا التأويل أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية عقيب قوله:
{إِنْ أدْرِى أقرِيبٌ مّا تُوعدُون أمْ يجْعلُ لهُ ربّى أمدا} [الجن: 25] يعني لا أدري وقت وقوع القيامة، ثم قال بعده:
{عالم الغيب فلا يُظْهِرُ على غيْبِهِ أحدا} أي وقت وقوع القيامة من الغيب الذي لا يظهره الله لأحد، وبالجملة فقوله:
{على غيْبِهِ} لفظ مفرد مضاف، فيكفي في العمل به حمله على غيب واحد، فأما العموم فليس في اللفظ دلالة عليه، فإن قيل: فإذا حملتم ذلك على القيامة فكيف قال:
{إِلاّ منِ ارتضى مِن رّسُولٍ} مع أنه لا يظهر هذا الغيب لأحد من رسله؟ قلنا: بل يظهره عند القرب من إقامة القيامة، وكيف لا وقد قال:
{ويوْم تشقّقُ السماء بالغمام ونُزّل الملائكة تنزِيلا} [الفرقان: 25] ولا شك أن الملائكة يعلمون في ذلك الوقت قيام القيامة، وأيضا يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعا، كأنه قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه المخصوص وهو قيام القيامة أحدا، ثم قال بعده: لكن من ارتضى من رسول:
{فإِنّهُ يسْلُكُ مِن بيْنِ يديْهِ ومِنْ خلْفِهِ} حفظة يحفظونه من شر مردة الإنس والجن، لأنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام جوابا لسؤال من سأله عن وقت وقوع القيامة على سبيل الاستهزاء به، والاستحقار لدينه ومقالته.واعلم أنه لابد من القطع بأنه ليس مراد الله من هذه الآية أن لا يطلع أحدا على شيء من المغيبات إلا الرسل، والذي يدل عليه وجوه أحدها: أنه ثبت بالأخبار القريبة من التواتر أن شقا وسطيحا كانا كاهنين يخبران بظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل زمان ظهوره، وكانا في العرب مشهورين بهذا النوع من العلم، حتى رجع إليهما كسرى في تعرف أخبار رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على شيء من الغيب وثانيها: أن جميع أرباب الملل والأديان مطبقون على صحة علم التعبير، وأن المعبر قد يخبر عن وقوع الوقائع الآتية في المستقبل، ويكون صادقا فيه وثالثها: أن الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر بن ملك شاه من بغداد إلى خراسان، وسألها عن الأحوال الآتية في المستقبل فذكرت أشياء، ثم إنها وقعت على وفق كلامها.قال مصنف الكتاب ختم الله له بالحسنى: وأنا قد رأيت أناسا محققين في علوم الكلام والحكمة، حكوا عنها أنها أخبرت عن الأشياء الغائبة أخبارا على سبيل التفصيل، وجاءت تلك الوقائع على وفق خبرها، وبالغ أبو البركات في كتاب المعتبر في شرح حالها، وقال: لقد تفحصت عن حالها مدة ثلاثين سنة حتى تيقنت أنها كانت تخبر عن المغيبات إخبارا مطابقا.ورابعها: أنا نشاهد (ذلك) في أصحاب الإلهامات الصادقة، وليس هذا مختصا بالأولياء بل قد يوجد في السحرة أيضا من يكون كذلك نرى الإنسان الذي يكون سهم الغيب على درجة طالعه يكون كذلك في كثير من أخباره وإن كان قد يكذب أيضا في أكثر تلك الأخبار، ونرى الأحكام النجومية قد تكون مطابقة وموافقة للأمور، وإن كانوا قد يكذبون في كثير منها، وإذا كان ذلك مشاهدا محسوسا، فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما يجر الطعن إلى القرآن، وذلك باطل فعلمنا أن التأويل الصحيح ما ذكرناه، والله أعلم.أما قوله تعالى:
{فإِنّهُ يسْلُكُ مِن بيْنِ يديْهِ ومِنْ خلْفِهِ رصدا} فالمعنى أنه يسلك من بين يدي من ارتضى للرسالة،
{ومِنْ خلْفِهِ رصدا} أي حفظة من الملائكة يحفظونه من وساوس شياطين الجن وتخاليطهم، حتى يبلغ ما أوحى به إليه، ومن زحمة شياطين الإنس حتى لا يؤذونه ولا يضرونه وعن الضحاك
«ما بعث نبي إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين (الذين) يتشبهون بصورة الملك».قوله تعالى:
{لّيعْلم أن قدْ أبْلغُواْ رسالات ربّهِمْ} فيه مسائل:المسألة الأولى:وحّد الرسول في قوله:
{إِلاّ منِ ارتضى مِن رّسُولٍ فإِنّهُ يسْلُكُ مِن بيْنِ يديْهِ ومِنْ خلْفِهِ} [الجن: 27] ثم جمع في قوله:
{أن قدْ أبْلغُواْ رسالات ربّهِمْ} ونظيره ما تقدم من قوله:
{فإِنّ لهُ نار جهنّم خالدين} [الجن: 23].المسألة الثانية:احتج من قال بحدوث علم الله تعالى بهذه الآية لأن معنى الآية ليعلم الله أن قد أبلغوا الرسالة، ونظيره قوله تعالى:
{حتى نعْلم المجاهدين} [محمد: 31] والجواب من وجهين الأول: قال قتادة ومقاتل: ليعلم محمد أن الرسل قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة، وعلى هذا، اللام في قوله:
{لِيعْلم} متعلق بمحذوف يدل عليه الكلام كأنه قيل: أخبرناه بحفظ الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ الحق، ويجوز أن يكون المعنى ليعلم الرسول أن قد أبلغوا أي جبريل والملائكة الذين يبعثون إلى الرسل رسالات ربهم، فلا يشك فيها ويعلم أنها حق من الله الثاني: وهو اختيار أكثر المحققين أن المعنى ليعلم الله أن قد أبلغ الأنبياء رسالات ربهم، والعلم هاهنا مثله في قوله:
{أمْ حسِبْتُمْ أن تدْخُلُواْ الجنة ولمّا يعْلمِ الله الذين جاهدوا مِنكُمْ} [آل عمران: 142] والمعنى ليبلغوا رسالات ربهم فيعلم ذلك منهم.المسألة الثالثة:قرئ
{لِيعْلم} على البناء للمفعول.أما قوله:
{وأحاط بِما لديْهِمْ} فهو يدل على كونه تعالى عالما بالجزئيات، وأما قوله:
{وأحصى كُلّ شيء عددا} فهو يدل على كونه عالما بجميع الموجودات، فإن قيل: إحصاء العدد إنما يكون في المتناهي، وقوله:
{كُلّ شيْء} يدل على كونه غير متناه، فلزم وقوع التناقض في الآية، قلنا: لا شك أن إحصاء العدد إنما يكون في المتناهي، فأما لفظة
{كُلّ شيْء} فإنها لا تدل على كونه غير متناه، لأن الشيء عندنا هو الموجودات، والموجودات متناهية في العدد، وهذه الآية أحد ما يحتج به على أن المعدوم ليس بشيء، وذلك لأن المعدوم لو كان شيئا، لكانت الأشياء غير متناهية، وقوله:
{وأحصى كُلّ شيء عددا} يقتضي كون تلك المحصيات متناهية، فيلزم الجمع بين كونها متناهية وغير متناهية وذلك محال، فوجب القطع بأن المعدوم ليس بشيء حتى يندفع هذا التناقض.والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيد المرسلين، وخاتم النبيين محمد النبي وآله وصحبه أجمعين. اهـ.
 .قال القرطبي:
.قال القرطبي:
قوله تعالى:
{قُلْ إِنْ أدري أقرِيبٌ مّا تُوعدُون} يعني قيام الساعة.وقيل: عذاب الدنيا؛ أي لا أدري ف(أن) بمعنى (ما) أو
{لا}؛ أي لا يعرف وقت نزول العذاب ووقت قيام الساعة إلا الله؛ فهو غيب لا أعلم منه إلا ما يعرفنيه الله.و(ما) في قوله:
{ما يُوعدُون}: يجوز أن يكون مع الفعل مصدرا، ويجوز أن تكون بمعنى الذي ويقدّر حرف العائد.
{أمْ يجْعلُ لهُ ربي أمدا} أي غاية وأجلا.وقرأ العامة بإسكان الياء من
{ربي}.وقرأ الحِرْميان وأبو عمرو بالفتح.
{عالِمُ الْغيْبِ فلا يُظْهِرُ على غيْبِهِ أحدا (26)} فيه مسألتان:الأولى: قوله تعالى:
{عالِمُ الغيب} {عالِمُ} رفعا نعتا لقوله:
{ربِّي}.وقيل: أي هو
{عالِمُ الغيب} والغيب ما غاب عن العباد.وقد تقدّم بيانه في أوّل سورة (البقرة)
{فلا يُظْهِرُ على غيْبِهِ أحدا إِلاّ منِ ارتضى مِن رّسُولٍ} فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه؛ لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات، ومنها الإخبار عن بعض الغائبات؛ وفي التنزيل:
{وأُنبِّئُكُمْ بِما تأْكُلُون وما تدّخِرُون فِي بُيُوتِكُمْ} [آل عمران: 49].وقال ابن جُبيرُ:
{إِلاّ منِ ارتضى مِنْ رسُولٍ} هو جبريل عليه السلام.وفيه بعدٌ، والأوْلى أن يكون المعنى: أي لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى أي اصطفى للنبّوة، فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه: ليكون ذلك دالا على نبوّته.الثانية: قال العلماء رحمة الله عليهم: لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه، كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحدٌ سواه، ثم استثنى من ارتضاه من الرسل، فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوّتهم.وليس المنجّم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه، بل هو كافر بالله مفترٍ عليه بحدسه وتخمينه وكذبه.قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألف إنسان على اختلاف أحوالهم، وتباين رتبهم، فيهم الملك والسُّوقة، والعالم والجاهل، والغنيّ والفقير، والكبير والصغير، مع اختلاف طوالعهم، وتباين مواليدهم، ودرجات نجومهم؛ فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله: إنما أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه، فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على اختلافها عند ولادة كل واحد منهم، ولم يبق إلا معاندة القرآن العظيم.وفيه استحلال دمه على هذا التنجيم، ولقد أحسن الشاعر حيث قال:
حكم المنجِّمُ أن طالع مولِدِي ** يقضِي عليّ بِميتةِ الغرِقِقُلْ لِلْمُنجِّمِ صبْحة الطُّوفانِ هلْ ** وُلِد الْجمِيعُ بكوْكبِ الْغرقوقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم والقمر في العقرب؟ فقال رضي الله عنه: فأين قمرهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر.فانظر إلى هذه الكلمة التي أجاب بها، وما فيها من المبالغة في الردّ على من يقول بالتنجيم، والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام النجوم.وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! لا تسر في هذه الساعة وسِرْ في ثلاث ساعات يمضين من النهار.فقال له علي رضي الله عنه: ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد، وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت.فقال عليّ رضي الله عنه: ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مُنجِّم، ولا لنا من بعده في كلام طويل يحتجُّ فيه بآيات من التنزيل فمن صدّقك في هذا القول لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نِدّا أو ضدّا، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك.ثم قال للمتكلم: نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنها.ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلاّ ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر؛ وإنما المنجم كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار، واللّهِ لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيتُ، ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان.ثم سافر في الساعة التي نهاه عنها، ولقي القوم فقتلهم وهي وقعة النهْروان الثابتة في الصحيح لمسلم.ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال قائل سار في الساعة التي أمر بها المنجم، ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجّم ولا لنا مِن بعده، فتح الله علينا بلاد كِسرى وقيصر وسائر البُلدان ثم قال: يا أيها الناس! توكلوا على الله وثِقوا به؛ فإنه يكفي ممن سواه.
{فإِنّهُ يسْلُكُ مِن بيْنِ يديْهِ ومِنْ خلْفِهِ رصدا} يعني ملائكة يحفظونه عن أن يقرب منه شيطان؛ فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة.قال الضحاك: ما بعث الله نبيا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبهوا بصورة الملك، فإذا جاءه شيطان في صور الملك قالوا: هذا شيطان فاحذره.وإن جاءه الملك قالوا: هذا رسول ربّك.وقال ابن عباس وابن زيد:
{رصدا} أي حفظة يحفظون النبيّ صلى الله عليه وسلم من أمامه وورائه من الجنّ والشياطين.قال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم أربعة من الملائكة حفظة.وقال الفراء: المراد جبريل؛ كان إذا نزل بالرسالة نزلت معه ملائكة يحفظونه من أن تستمع الجنّ الوحي، فيلقوه إلى كهنتهم، فيسبقوا الرسول.وقال السديّ:
{رصدا} أي حفظة يحفظون الوحي، فما جاء من عند الله قالوا: إنه من عند الله، وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان.و
{رصدا} نصب على المفعول.وفي الصحاح: والرّصد القوم يرصُدون كالحرس، يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وربما قالوا أرصادا.والراصد للشيء الراقب له؛ يقال: رصده يرْصُده رصْدا ورصدا.والتّرصد الترقب والمرْصد موضع الرّصد.قوله تعالى:
{لِّيعْلم}قال قتادة ومقاتل: أي ليعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلّغ هو الرسالة.وفيه حذف يتعلق به اللام؛ أي أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحقّ والصدق.وقيل: ليعلم محمد أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالة ربه؛ قاله ابن جبير.قال: ولم ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلام.وقيل: ليعلم الرسل أن الملائكة بلّغوا رسالات ربهم.وقيل: ليعلم الرسول أيُّ رسول كان أن الرسل سواه بلّغوا.وقيل: أي ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليطه واستراق أصحابه.وقال ابن قتيبة: أي ليعلم الجنّ أن الرسل قد بلّغوا ما نزل عليهم ولم يكونوا هم المبلّغين باستراق السمع عليهم.وقال مجاهد: ليعلم من كذّب الرسل أن المرسلين قد بلّغوا رسالات ربهم.وقراءة الجماعة
{لِيعْلم} بفتح الياء وتأويله ما ذكرناه.وقرأ ابن عباس ومجاهد وحُميد ويعقوب بضم الياء أي ليُعْلِم الناس أنّ الرسل قد أبلغوا.وقال الزجاج: أي ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته بفتح الياء؛ كقوله تعالى:
{ولمّا يعْلمِ الله الذين جاهدُواْ مِنكُمْ ويعْلم الصابرين} [آل عمران: 142] المعنى: ليعلم الله ذلك علم مشاهدة كما علمه غيبا.
{وأحاط بِما لديْهِمْ} أي أحاط علمه بما عندهم، أي بما عند الرسل وما عند الملائكة.وقال ابن جبير: المعنى: ليعلم الرسل أن ربهم قد أحاط علمه بما لديهم، فيبلّغوا رسالاته.
{وأحصى كُلّ شيْءٍ عددا} أي أحاط بعدد كل شيء وعرفه وعلمه فلم يخف عليه منه شيء.و
{عددا} نصب على الحال، أي أحصى كل شيء في حال العدد، وإن شئت على المصدر، أي أحصى وعدّ كل شيء عددا، فيكون مصدر الفعل المحذوف.فهو سبحانه المحصي المحيط العالم الحافظ لكل شيء.وقد بينا جميعه في الكتاب الأسنى، في شرح أسماء الله الحسنى.والحمد لله وحده. اهـ.